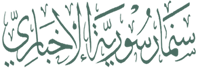تحية من سورية إلى كل الكوادر الطبية في العالم وجهودها العظيمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد وأمراض السرطان)
(Greetings from Syria to Medical Staff All Around the Word, and their Great Efforts in Combating Novel Corona Virus And cancer diseases)
بقلم: المؤرخ الدكتور محمود السيد-المديرية العامة للآثار والمتاحف– والإعلامي محمد عماد الدغلي
توثق بعض الأدلة الأثرية معرفة الإنسان في عصور ما قبل التاريخ إلى بعض الآليات التي يعمل بها الجسم البشري، ويمكننا تأكيد ذلك من خلال نتائج دراسة طقوس الدفن الجنائزي لإنسان النياندرتال المكتشفة بقاياه في سورية والعالم والتي تشير إلى معرفته ببعض الأمور المتعلقة ببنية العظام. فقد عثر على عظامٍ جُرّدت من اللحم وبُيِّضت وجُمِّعت معاً وفقاً للجزء الذي أُخذت منه من الجسم. وتوثق دراسة البقايا والهياكل العظمية للإنسان معرفته لأمراض السرطان منذ العصر الحجري القديم منذ مليون وسبعمائة ألف عام على الأقل (راجع الجزء الثالث من سلسلة زبدة الطلب في تاريخ أمراض السرطان وإنجازات الطب والأطباء) وإن كانت الإصابات قليلة كون بيئة الإنسان في تلك العصور لم تعرف التلوث الصناعي كما هو الحال في عصرنا، فضلا عن خلو نظامه الغذائي من الأطعمة المصنعة، خاصة وأن الطب يؤكد عبر جميع المراحل والعصور التي مر بها العلاقة المباشرة بين النظام الغذائي وخطر الإصابة بالسرطان.
وتؤكد دراسة البقايا الآدمية بواسطة تقنيات الطب الحديث والطب الشرعي أن السرطان هو مجموعة أمراض يمكنها أن تصيب كل أجزاء الجسم البشري وفي أيّ مرحلة عمريّة، حتّى إنّه قد يصيب الأجنّة، ولكن تزيد مخاطر الإصابة به كلّما تقدّم الإنسان في العمر. ويجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا من وجهة نظر علم الآثار أن العديد من سرطانات العظام لا يمكن اكتشافها على البقايا الأحفورية، حيث قد لا يترك ورم العضو أو سرطان الدم علامة دالة عليه بعد مضي مليون عام على وفاة الشخص وهذا ما يجعل البقايا الآدمية المصابة بالسرطان والمؤرخة بالعصر الحجري القديم قليلة بين أيدينا فضلا عن صعوبة تحديد ما إذا كان الورم السرطاني موضعي أو نقيلي.
وقد اعتمد المصريون القدماء في تحنيط جثث الموتى وحفظها من التلف على بعض النباتات: كالكتان والحناء ونبيذ البلح (العرقي) ونشارة الخشب وثمار العرعر والبصل والقرفة وخيار شمبر والمر واللبان والصمغ الى جانب ملح النطرون.
وبفضل الطب الحديث والمعاصر تمكنا من خلال دراسة المومياوات الفرعونية من التعرف على الكثير من الأوبئة التي هددت حياة البشر وخاصة مع ظهور مفهوم المدنية والتمدن وما رافق ذلك من تجمعات بشرية كبيرة. فدراسة البقايا العظمية والمومياوات الفرعونية تزودنا بمعلومات قيمة حول وقت الوفاة وسببها ووزن الشخص المتوفى، والأمراض التي كان يعاني منها، والطول، والنظام الغذائي، والعمر، وحالة العظام.
وتمثل بقايا العظام أداة قوية للاستدلال على الأمراض المختلفة، وتحديد تاريخها كما هو الحال في مرض السُلّ من خلال دراسة الضرر الذي يُخلِّفه على العظام. كما أن البيانات الجينية المستخرجة من الجثث يمكنها أن تقدم معلومات أيضاً عن الأمراض التي تعرّض لها الجسم. وعن طريق تحليل عيّنات الحمض النووي يمكن للعلماء تحديد نوع الأمراض والآثار التي تركتها على الجسم.
وتؤكد معرفة الإنسان القديم لمرض السرطان الموضعي والنقيلي وأمراض أخرى اختلفت قليلًا عمّا هي عليه اليوم منها التهاب المفصل التنكسيّ، بسبب اضطرار قدماء البشر لحمل الأشياء الثقيلة، مما يُسبِّب ضغطًا على مفاصل الركبة. والمعاناة من فرط تمديد أسفل الظهر نتيجةً لنقل ورفع الصخور والحجارة الكبيرة وكسور صغيرة في العمود الفقريّ وانحلال الفقرات ناجمة بشكل رئيسي عن سحب الصخور الكبيرة لمسافاتٍ طويلةٍ. كما انتشرت لديهم الجروح والكدمات والكسور بشكلٍ متكرر. والكساح حيث يعتقد علماء الأنثروبولوجيا بشيوع المرض في فترات ما قبل التاريخ، ربّما بسبب نقص فيتامين د وفيتامين ج. وتشوه العظام ولين العظام، الذي يسببه نقص فيتامين د.
السرطان مرض مرتبط بشكل رئيسي بالتقدم في العمر لأن الوقت عامل رئيسي يحتاجه المرض لكي يتكاثر ويثبت دعائمه في جسم الإنسان لذلك يزداد حدوثه بعد سن الخمسين من العمر مع إمكانية الإصابة به لمن هم دون هذا السن. وبعض أنواع السرطان تنمو وتنتشر بسرعة وبعضها الآخر يكون نموه بطيئا. وهناك تشابه في بعض الصفات للأنواع المختلفة لمرض السرطان ويكمن الخلاف في طرق النمو والانتشار.
وعندما تنتشر خلايا السرطان في الجسم تسمى هذه العملية النقيلة الانبثاث وهي عملية تتم من خلالها انتشار خلايا السرطان إلى مناطق بعيدة في الجسم من خلال الجهاز الليمفاوي أو الدم. وكلما زادت مرحلة السرطان في التقدم كلما كان انتشاره بدرجة أكبر، وقد ينتشر السرطان من مكانه إلى الرئة والكبد والدم وغيرها من أعضاء الجسم، ويعتمد ذلك على درجة السرطان ونوع العضو المصاب به. كذلك تستطيع خلايا السرطان في الرئة مثلا أن تنتشر إلى العظام وتنمو فيها. علما أن خلايا السرطان في العظام تشبه تماما الخلايا السرطانية في الرئة ولا يسمى السرطان بسرطان العظام إلا إذا كان قد بدأ فعلا بالعظام.
إذا تستطيع بعض الخلايا السرطانية أن تنتشر من موضعها الأصلي إلى أماكن أخرى في الجسم لتتابع النمو والانقسام في ذلك المكان الجديد. ويتم ذلك عن طريق النقيلات، ويظل السرطان المنتقل محتفظاً بخصائصه الأصلية بعد الانتقال. فحين ينتقل سرطان الرئة إلى العظام مثلاً، فإنه يظلّ محتفظاً بخصائصه الخلوية المميزة لسرطان الرئة، ولذلك تكون النقيلات مشابهة لمصدرها، وليس لوجهتها. ويمكن للسرطان أن ينشأ بطريقتين: إما من الخلايا العادية أو من الخلايا الجذعية. فالمصادر المختلفة قد تكون السبب في اختلاف خاصيات الأورام الخبيثة والعلاقات القائمة بينها.
ساهم التقدم التكنولوجي الطبي الحديث وبفضل استخدام تقنية الأشعة السينية وأشعة التصوير المقطعي والمجاهر الإلكترونية والقياس الطيفي للكتلة وتقنيات الطب الشرعي في دراسة عظام وأعضاء المومياوات في فهم الكثير من الأمراض التي عرفها الإنسان عبر مختلف العصور التاريخية ومنها أمراض السرطان وقد تكون أسباب الإصابة بالسرطان والتي ثبت وجودها في المومياوات موضوع الدراسة الراهنة ناجمة عن التهابات مزمنة بسبب التعرّض لعدوى مزمنة، أو نتيجة المعاناة من السمنة، أو نتيجة تفاعل الجهاز المناعيّ مع الخلايا السليمة بشكل غير طبيعيّ، وبمرور الوقت قد يُحدث الالتهاب تغييرات في الحمض الريبوزي النووي المنزوع الأكسجين، وهذا بدوره يتسبب بالسرطان، والمصابين بداء الأمعاء الالتهابيّ مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي يكونون أكثر عُرضة للإصابة بسرطان القولون. وقد تحدث الإصابة بالسرطان عن طريق الوراثة في الجينات التالفة من أحد الأبوين، حيث يرث من أحد والديه ضعف الخلايا، فتنمو الخلايا وتتكاثر بطريقة منظمة، ومع تلف الخلايا وعدم قدرتها على النمو ومقاومة السرطان تبدأ الخلايا الميتة في تكوين كتلة من الورم.
الفيروسات هي العوامل المعدية المعتادة التي تسبب السرطان ولكن البكتيريا والطفيليات السرطانية قد تلعب دوراً أيضاً. ومن أهم الفيروسات المرتبطة بالسرطانات هي فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد الوبائي ب والتهاب الكبد الوبائي سي وفيروس إيبشتاين– بار وفيروس الهربس المرتبط بساركوما كابوزي وفَيْروسُ اللَّمْفومةِ. وبكتيرية المَلوية البوابية والتي تُحدث التهاب في جدار المعدة وقد تؤدي إلى إصابتها بالسرطان. وتشمل العدوى الطفيلية المرتبطة بالسرطان البلهارسيا (سرطان الخلايا الحرشفية في المثانة) وتدفقات الكبد، ومتأخر الخصية الزبادي وسرطان القنوات الصفراوية.
السرطان بشكل عام ليس معدياً لدى البشر ولكن بعض الدراسات الطبية الحديثة المنشورة في مجلة نيتشر البريطانية قد أشارت إلى إمكانية أن يكون السرطان لدى بعض الحيوانات معدياً، خاصة لدى أصداف البحر. وذكرت الدراسة أن مرضا شبيها بسرطان الدم يمكن أن ينتقل من إحدى الأصداف إلى غيرها. وأن إصابة هذه الأصداف بالسرطان تظهر على شكل فائض من الخلايا الكبيرة المتغيرة في نظام الدورة الدموية وإن سائل اللمف الدَموى، خليط بين الدم واللمف ضروري لنظام الدورة الدموية، داخل الحيوانات المصابة، يبدو سميكا وغير شفاف جراء الإصابة وإن أنسجة الحيوانات التي أصابتها العدوى تسَد شيئاً فشيئاً من خلال الخلايا السرطانية. ولفتت الدراسة إلى حالات من عدوى السرطان لدى الكلاب.
وتعد حالات انتقال المرض بين البشر نادرة، وتحدث مثلاً في حالة نقل أعضاء، وأحياناً أثناء الحمل، حيث ينتقل المرض من الأم للجنين في حالات نادرة. وقد يكون هناك ارتباط بين مرض داء السكري المذكور في البرديات الطبية المصرية وسرطان البنكرياس والذي يبدأ في أنسجة البنكرياس التي تحرر إنزيمات تساهم في الهضم، وهرمونات منها الأنسولين الذي يساهم في تنظيم سكر الدم. وتبدأ معظم سرطانات البنكرياس في الخلايا التي تُبطِّن القنوات البنكرياسية، ويُدعى هذا النمط من السرطان بالسرطان الغُدِّي (أدينوكارسينوما)، أو سرطان البنكرياس الغدي خارجي الإفراز. ولكن وبشكل نادر قد يتشكل السرطان في الخلايا المُفرِزة للهرمون أو الخلايا العصبية الصماوية ضمن البنكرياس، وتُدعى هذه الأنماط من السرطان بأورام خلايا الجزر البنكرياسية وسرطان البنكرياس داخلي الإفراز وأورام البنكرياس العصبية الصماوية. وينتشر السرطان عادةً بسرعة إلى الأعضاء المجاورة، ونادراً ما يُكتَشَف في مراحله الباكرة.
وإحدى علامات سرطان البنكرياس هو السكري خاصة عندما يحدث مع فقدان وزن أو يرقان أو ألم في أعلى البطن ينتشر إلى الظهر. وأعراض سرطان البنكرياس لا تظهر عادةً إلا في مراحلَ متقدمة وقد تتضمن: ألم في أعلى البطن ينتشر إلى الظهر، فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المقصود، اكتئاب، سكري حديث البدء، جلطات دموية، تعب، تلون الجلد وبياض العين باللون الأصفر (يرقان). ومن أسباب تزايد تطور سرطان البنكرياس: التهاب البنكرياس المزمن وداء السكري والتاريخ العائلي للمتلازمات الجينية التي تزيد خطر الإصابة بالسرطان ومنها طفرة الجين ومتلازمة لينش والمتلازمة العائلية لميلانوما الوحمة الخبيثة غير النموذجية والسوابق العائلية لسرطان البنكرياس والتدخين والبدانة والعمر المتقدم، فمعظم المرضى يُشخَّصون بعمر أكبر من 65.
ومن الممكن تقليل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس في تاريخنا المعاصر عبر إيقاف التدخين والمحافظة على وزن صحي واتباع نظام غذائي صحي متوازن. وقد تتضمن المعالجة الجراحة والمعالجة الكيمياوية والمعالجة الشعاعية أو اجتماع عدة علاجات منها معاً.
وأثبتت نتائج الدراسات الطبية الحديثة الصادرة عن معهد قطر لبحوث الطب الحيوي وجامعة امبريال كوليدج لندن والمركز الوطني للبحث العلمي بجامعة ليل الفرنسية والمنشورة في مجلة نيتشر جينيتكس عام 2013 عن وجود علاقة جينية بين مرض داء السكري ومرض السرطان وأن المرضى المصابون بداء السكري من النوع 2 هم أكثر عرضة للإصابة بأنواع معينة من السرطان وبشكل خاص سرطان الدم بما في ذلك الورم اللمفي واللوكيميا. وهذا ما يوثق طبياً صحة ما ذكر في البرديات المصرية الطبية والتي ربطت بشكل غير مباشر بين داء السكري والاصابة بأمراض السرطان.
وقد تتحول خلايا الجلد السليمة إلى أورام خبيثة وإلى سرطان وليس فقط الخلايا الجذعية. ويصاب البشر بسرطان الجلد عندما يفقد الحمض النووي خاصيته في معالجة الطفرات الناتجة عن اختراق الأشعة فوق البنفسجية للجلد. فتعرض الانسان لفترات طويلة لأشعة الشمس فوق البنفسجية والمواد المشعة يؤذي الجلد ويؤدي إلى تغييرات تنكسيه في خلايا الجلد والأنسجة الليفية والأوعية الدموية. فالأشعة فوق البنفسجية، وخاصة الموجة المتوسطة غير المؤينة للأشعة فوق البنفسجية، هي سبب معظم حالات سرطان الجلد غير الميلانيني، وهي أكثر أشكال السرطان شيوعًا في العالم. ولسرطان الجلد ثلاث أنواع رئيسية هي سرطان الجلد ويمكن أن يحدث في أي مكان في الجسم سواء في الجلد العادي أو في الشامة التي تصبح سرطانية. وسرطان الخلايا الحرشفية والذي يصيب عادةً المناطقَ المعرَّضة لأشعة الشمس من الجسم، مثل الرقبة، أو الوجه ويظهر في شكل عقيدة حمراء، صلبة أو نتوء لؤلؤي أو شمعي، أو آفة مسطحة بلون الجلد مع سطح حرشفي متقشر، أو على شكل نُدْبة بِلَون بني، قرحة نازفة، أو قشرية تلتئم ثم تعود مرة أخرى ويكاد يكون قابلاً للشفاء بالمطلق عند اكتشافه مبكراً. وسرطان الخلايا القاعدية المرتبط بالتعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية وتظهر سرطانات الخلايا القاعدية في بعض الأحيان بشكل شبه شفاف أو شمعي. كما قد تظهر الكتل السرطانية على شكل قروح، أو بقع متقشرة، أو انتفاخات تشبه الكيس أو على شكل بثرة لؤلؤية، رأسها مدبب، حمراء اللون. وهذه السرطانات عادة ما تكون بطيئة النمو وقابلة للعلاج بدرجة كبيرة. ومن أنواع سرطان الجلد الأخرى ساركوما كابوسي والذي يصيب من لديهم ضعف في الجهاز المناعي، كالمصابين بالإيدز، ومن يتناول أدوية تُثبط مناعتهم الطبيعية، ويظهر السرطان في الأوعية الدموية بالجلد ويَتسبب في ظهور بقع حمراء أو أرجوانية على الجلد أو الأغشية المخاطي. وسرطان خلايا ميركل ويتسبب في ظهور عقيدات قوية لامعة على الجلد أو أسفله وفي جريبات الشعر. وغالبًا ما يَظهر على الرأس والعنق والجذع. وسرطان الغدد الدهنية والذي يُصيب الغدد الدهنية في الجلد. ويَظهر عادة في أي مكان في صورة عقيدات صلبة وغير مؤلمة، ويَظهر معظمها على جفن العين. والورم الميلانيني ويمكن للوراثة أن تلعب دورا في الإصابة به، حيث يمكن مثلا وراثة بعض الجينات التي يوجد بها خلل والتي قد تؤدي إلى تغييرات الحمض النووي في بعض الجينات وإذا تضررت هذه الجينات بفعل الاشعة البنفسجية، قد تتوقف عن أداء وظيفتها في التحكم في نمو الخلايا مسببة الإصابة بهذا النوع من سرطان الجلد. وسرطان جلد اللاميلانوما. ومن غير المستغرب إصابة فراعنة مصر وبشكل خاص عمال البناء بسرطان الجلد نتيجة التعرض لمدة طويلة لأشعة الشمس وخاصةً في وقت الذروة.
ودراسة بقايا هيكل عظمي لذكر يقدر عمره بين 25 و35 عاما عند وفاته ويؤرخ بحوالي 3000 عام، اكتشفه عام 2013 باحثون من جامعة درم والمتحف البريطاني في مقبرة في شمال السودان على بعد 750 كيلومترا من العاصمة الخرطوم وتحليله باستخدام التصوير بالأشعة والفحص بالمجهر الالكتروني تؤكد إصابته بأورام سرطانية تطورت وانتشرت في كامل الجسم. وتظهر التحليلات ندوب صغيرة على العظام لا تنجم سوى عن أنسجة ضعيفة مصابة بالسرطان. وتوثق انتشار السرطان وتسببه في أورام في عظام الترقوة والكتفين والذراعين وفقرات العنق والأضلع والحوض وعظام الفخذين. ويمثل هذا الاكتشاف أقدم مثال مكتمل في العالم لإنسان انتشر السرطان في جسده.
وقد يكون المريض قد أصيب بالسرطان بسبب عوامل بيئية مثل دخان حرائق الغابات أو بسبب عوامل جينية أو مرض معد مثل البلهارسيا التي تسببها الطفيليات. فمرض البلهارسيا ينتشر بين سكان مصر والنوبة منذ عام 1500 قبل الميلاد ويعد سببا للإصابة بسرطان المثانة لدى الرجال (يصيب بشكل عام كبار السن من الرجال. ومن أسباب الإصابة به عند النساء انقطاع الطمث المبكر (قبل سن 45)، وللجنسين تهيج خلايا المثانة والتهابها المزمن نتيجة إصابتها بمرض البلهارسيا يؤدي إلى الإصابة). وتحليل الحمض النووي للهياكل العظمية والمومياوات التي تتضمن أدلة على الإصابة بالسرطان، يمكن أن يستخدم في تحديد الطفرات التي حدثت لجينات محددة معروف ارتباطها بأنواع معينة من السرطان.
وبفضل استخدام جهاز المسح المقطعي البالغ الدقة، والقادر على كشف أورام بقطر أقل من 1 مليمتر تبين أثناء دراسة بقايا مومياء (المومياء رقم 1) لرجل فرعوني يقدر عمره بين 51-60 عام أن سبب الوفاة ناجم عن إصابة الرجل بسرطان البروستاتا (البروستاتا هي منطقة الجهاز التناسلي وينتشر الورم حول غدة في الجهاز التناسلي الذكري، بمعدل بطيء جداً، لذلك يمكن اكتشافها والتعرف عليها سريعاً والتقدم في السن وتاريخ العائلة وهرمون الأندروجين أهم أسباب الإصابة. ويدل على الإصابة حدوث تغيير في طريقة التبول وصعوبة البدء في التبول أو إفراغ المثانة وتدفق ضعيف عند التبول، والشعور بأن المثانة لم تفرغ بشكل صحيح، وسيلان البول والحاجة للتبول باستمرار خاصة في الليل، والرغبة المفاجئة للتبول مع عدم القدرة على حفظه. وفي حال تقدم المرض يشعر المريض بآلام في الظهر أو الورك أو الحوض، وفقدان الوزن بطريقة غير طبيعية).
واكتشف في عام 2015 في إحدى المقابر الفرعونية (جبانة قبة الهواء) غرب مدينة أسوان، هيكل عظمي لإحدى النساء ينسب إلى عصر الأسرة السادسة (2345-2181 قبل الميلاد)، وعليه تشوهات غير مألوفة وتؤكد نتائج الدراسة المستخلصة بفضل استخدام تقنيات الطب الحديث وجود بقايا آثار مرض خطير أدى إلى تدهور صحة المرأة وإصابتها بسرطان الثدي (يصيب الإناث بشكل خاص وينجم عن نمو غير طبيعي لخلايا الثدي. ويبدأ بإصابة البطانة الداخلية لقنوات الحليب أو الفصوص التي تغذيها بالحليب ويصنف إلى سرطان قنوي أو سرطان فصيصي بحسب موقع نشؤه وهذا النمط من السرطان قادر على الانتشار في مواقع أخرى من جسم الانسان). ويؤكد انتشار الورم الخبيث بين العظام، انتقال السرطان من الثدي وانتشاره في سائر أنحاء الجسم، ويمثل هذا الاكتشاف في ضوء المعطيات الأثرية الحالية أقدم حالات الإصابة بسرطان الثدي في تاريخ البشرية. وربما سبب الإصابة ناجم عن التفاعل المعقَّد للتكوين الجيني وللبيئة التي كانت تعيش فيها المرأة أو أن الإصابة مرتبطة بالطفرات الوراثية التي تنتقل عبر أجيال العائلة، أو هناك أسباب أخرى. علما أن سرطان الثدي ناجم عن بدء بعض خلايا الثدي في النمو بطريقة غير طبيعية وينجم عن ذلك انقسام هذه الخلايا بسرعة أكبر من الخلايا السليمة وتراكمها، لتشكل كتلة أو ورماً. وقد تنتقل الخلايا من خلال الثدي إلى العُقَد اللمفية، أو إلى أجزاء أخرى من الجسم.
وإلى مصر القديمة ينسب أول تدوين كتابي في العالم يشخص مرض سرطان الثدي، ففي بردية إدوين سميث البالغ طولها خمسة أمتار والمؤرخة بالقرن السادس عشر قبل الميلاد بعصر المملكة المصرية الوسطى والمحفوظة حاليا في أكاديمية نيويورك للطب والمتخصصة بالأمراض الجراحية والتي وثقت أقدم وصف كتابي معروف في العالم حتى اليوم لسرطان الثدي وأقدم علاج جراحي للسرطان. “إذا صادفتك حالة فيها كتل بارزة، منتشرة في الثدي، وكانت باردة، ودون تحببات، ولا تحتوي سوائل، ولا ينزّ منها سائل، فيجب أن تقول عنها: هذه حالة كتل بارزة ينبغي أن أوجهاها وأتغلب عليها.. الكتل البارزة في الثدي تعني وجود تورّمات كبيرة. هذا التورّم: لا يوجد له علاج”.
ويتضح من النصوص المصرية أن عملية الكشف عن سرطان الثدي كانت يدوية تقوم على البحث عن الأورام باللمس (فحص يدوي تقليدي من خلال الضغط على أنسجة الثدي). ولكن هذه العملية غير دقيقة وعشوائية نسبيا. ويتم الفحص الذاتي للثدي برفع اليد فوق الرأس وبواسطة أصابع اليد الأخرى يتم تحسس الثدي بحركات دائرية مع المرور على منطقة الإبط لتحسس وجود الكتل مع الانتباه لشكل الجلد وحجم الثدي ومظهر الحلمتين. وتوثق البرديات الطبية المصرية القديمة 8 حالات من الاورام التي تصيب الثدي، وتم علاجها عن طريق الكي الذي يساعد في تدمير الأنسجة وذلك عن طريق استخدام أداة ساخنة تسمى “حفر النار”، ولكن لم تكن طريقة العلاج هذه فعالة للقضاء على الورم. والنقوش الطبية المصرية أقدم مصدر كتابي في العالم يشجع على الرضاعة الطبيعية ويؤكد الطب الحديث أن ذلك يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي عند الأم، كما أنها تساعد على تمتع الطفل بمقاومة حسنة ضد الحساسية. وينوه مضمون البرديات الطبية المصرية على أهمية الحالة المعنوية المرتفعة للمريضة كأحد اهم اعمدة علاج سرطان الثدي.
ودراسة عدد من الهياكل المكتشفة في مقابر بواحة الداخلة في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، تؤكد إصابة عدد من الفراعنة بأنواع عديدة من مرض السرطان منها سرطان العظام (أورام العظام الخبيثة الأولية نادرة وتصيب بشكل أكبر الأطفال. ومعظم سرطانات العظام تظهر على شكل ورم عظمي يؤثر عل العظام الطويلة في الركبة، وعظم الفخذ والساق. أما ورم إيوينغ فينجم عن خلل جيني وهو تحول مورثي أي انتقال مورثة من صبغية الى أخرى الكروموسومات أحدا عشر واثنان وعشرون. وهو أكثر شيوعا بكثير من السرطانات البدائية لأن، معظم السرطانات تؤدي للانبثاث في العظام). وسرطان عنق الرحم (ينجم عن خلايا تنمو خارج السيطرة في منطقة عنق الرحم وعادة يتطور وينتشر بشكل بطيء. ويصيب الجزء الأنبوبي من الرحم؛ أي الجزء الذي يربط جسم الرحم بالمهبل ويسبب نزيف مهبلي غير طبيعي وقد يؤدي إلى ظهور بعض الزوائد اللحمية في المنطقة التناسلية)، سرطان الخصية (يتولد جراء نمو غير عادي لخلايا غير طبيعية في الخصيتين الموجودتان داخل كيس جلديّ تحت القضيب يسمى الصفن وهما المسؤولتان عن انتاج وتخزين السائل المنوي وإنتاج هُرمون تستوستيرون. ويمر نمو سرطان الخصية بثلاث مراحل أولى يصيب فيها المرض الخصية فقط دون أن ينتشر في العقد اللمفية المعنية أو الأعضاء وفي المرحلة الثانية ينتشر المرض إلى العقد اللمفية خلف الصفاق في المنطقة الخلفية من البطن وفي المرحلة الثالثة ينتشر المرض في مجرى الدم). وسرطان المستقيم (مع تقدم العمر، يزداد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وخاصة في حالة وجود العامل الوراثي او الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والذي يزيد إمكانية الإصابة بثلاث أضعاف لأن الأنسولين المهم بالنسبة لعلاج داء السكر، لا يقلل من نسبة السكر في الدم فحسب، بل ويعزز النمو السرطاني. ويسبب سرطان القولون فقر الدم أو نزيف المستقيم وقد يؤدي سرطان القولون والمستقيم إلى تضييق أو انسداد في الأمعاء، مما يؤثر على عادات الأمعاء). وسرطان الثدي، وسرطان المبيض (يتكون جهاز التناسل الأنثوي من مبيضين يتواجد كل منهما على أحد جانبي الرحم. وينتج البيوض بالإضافة للهرمونات (الإستروجين والبروجسترون). يُصيب سرطان المبيض بشكل عام النساء المتقدمات في السن، خاصةً بعد سن الستين ومن أسباب الإصابة الطفرات الجينية الموروثة والطفرات المرتبطة بمتلازمة لينش وينجم المرض نتيجة لنمو خلايا غير طبيعية في أحد المبيضين أو في كليهما. ويتحدد كل نوع من سرطان المبيض بنمط الخلايا التي يبدأ بها وأكثرها شيوعا الأورام الظهارية التي تنمو في النسيج المغطي للمبيضين، وتحدث عادةً بعد انقطاع الطمث. وهناك أورام اللحمة وتبدأ في نسيج المبيض الذي يحتوي على الخلايا المُنتجة للهرمون. وأورام الخلية المنتشة وتبدأ في الخلايا المُنتِجة للبيوض، وتصيب عامة الإناث صغار السن).
وسرطان القولون، وسرطان الدم (تتكون خلايا الدّم في نخاع العظم كخلايا جذعيّة وتبدأ بالنّضوج لاحقاً لتُشكّل مُختلف مُكوّنات الدّم (كخلايا الدم الحمراء، وخلايا الدم البيضاء، والصّفائح الدمويّة) وتنتقل بعدها إلى مجرى الدّم. ويصاب الدم بالسرطان “اللوكيميا”, حيث يستهدف الخلايا الدموية الناشئة في النخاع العظمي ويؤدي إلى إنتاج خلايا دم غير طبيعية في نخاع العظم وعادةً ما تتسبب اللوكيميا في إنتاج كريات دم بيضاء غير طبيعية. وتستمر خلايا اللوكيميا التي تدخل مجرى الدم في النمو والانقسام، إلى أن تزاحم خلايا الدم الطبيعية والسليمة في النهاية، وبذلك تؤثّر عليها وتمنعها من القيام بوظائفها بالشّكل المطلوب. وهي لا تشكل أوراماً صلبة، فتتراكم الخلايا السرطانية في الدم وأحياناً نخاع العظام. وتصنف أنواع سرطانات الدم بحسب سرعة تطورها أو بحسب الخلايا التي تستهدف التأثير فيها ومن الأنواع سرطان الدّم الحادّ وتنمو فيه الخلايا السرطانيّة بسرعة كبيرة جدّاً، ويُنتِج نُخاع العظم أعداداً كبيرةً من خلايا الدم البيضاء غير النّاضجة والشّاذة والتي تدخل إلى مجرى الدم، وتعمل على مُزاحمة الخلايا الطبيعيّة وتعطيل وظيفتها في مقاومة العدوى أو إيقاف النّزيف أو منع حدوث فقر الدّم. وسرطان الدّم الليمفاويّ الحادّ. وسرطان الدم النقيانيّ (النخاعيّ) الحادّ. وسرطان الدم المزمن والذي يتطوّر ببُطء ويتفاقم بالتّدريج، ولا تظهر الأعراض فيه إلا بعد مرور فترة طويلة، وله نوعان رئيسان هما سرطان الدّم الليمفاويّ المُزمن وسرطان الدّم النقيانيّ (النخاعي) المُزمن. ومن بين أسباب الإصابة عوامل جينية وبيئية، نتيجة اكتساب خلايا الدم طفراتٍ في صبغتها الجينية التي تجعلها تنمو بشكل غير طبيعي وتفقد وظائف خلايا الدم البيضاء النموذجية أو بعض التغييرات في الحامض النووي للخلية).
وهذه النتائج استخلصت بعد إجراء التحليل الباثولوجي (علم دراسة وتشخيص الأمراض، يدرس رد فعل الأنسجة على الإصابة والأمراض التي تصيب الأجهزة في جسم الإنسان) لتلك الهياكل، والتقاط سلسلةً من الصور الشعاعية لها، وإجراء تحليلات لبقايا الآفات والثقوب، والتي تؤكد أن هذه الثقوب على العظام ناجمة عن أمراض السرطان. وتم تشخيص إصابة اثنتين من النساء الأصغر سنًّاً بسرطان عنق الرحم والذي يصيب خلايا عنق الرحم (الجزء السفلي من الرحم المتصل بالمهبل) عندما تنشأ تغيرات في الحمض النووي لتلك الخلايا وربما يكون سبب الإصابة فيروس الورم الحليمي البشري الذي يسبب ظهور زوائد على الجلد أو الأغشية المخاطية (بثور). وينجم عن عدوى منقولة جنسيا أو من خلال الاتصال المباشر بالجلد. ورجل أصيب بسرطان الخصية الناجم عن نمو غير عادي لخلايا غير طبيعية في الخصيتين. ورجل مسن مصاب بسرطان المستقيم (الجزء الأخير من القولون ويتصل بنهاية مع فتحة الشرج) بسبب بدء الخلايا المكونة للمستقيم بالانقسام والنمو بشكل عشوائي (في الماضي كان علاج سرطان المستقيم معقدا وفي أغلب الأحيان غير ممكن بسبب ضيق المساحة التي يوجد فيها المستقيم وقربه من عدد من الأعضاء الموجودة داخل الحوض) ويسبب الشعور بالتعب والإعياء وخروج دم مع البراز وتغير في نشاط الأمعاء، ومعاناة المصاب من الإسهال، أو الإمساك، أو الشعور بعدم إفراغ الأمعاء بشكلٍ كامل، أو تغيّر شكل البراز، وخروج مادة مخاطية مع البراز والشعور بالانتفاخ، والألم، والامتلاء، وتقلّصات البطن، والشعور بالألم خلال حركة الأمعاء، والإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.
وامرأة أكبر سنًّاً مصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض الذي يسبب غازات وألم وانتفاخ البطن والاسهال والامساك وتهيج المعدة وسرطان القولون (الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة، من الجهاز الهضمي) ويسبب تغيُّراً مستمرَّاً في حركة الأمعاء (الإسهال أو الإمساك، أو تغيُّرًا في تماسك البراز) ونزيفاً شرجيّاً، أو دماً في البراز واضطرابات مستمرة في البطن (تقلُّصات مؤلمة أو غازات أو الألم) وشعوراً بأن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماماً وبالضعف أو الإرهاق وفُقدان الوَزن غير المُفسَّر. وطفل يتراوح عمره بين الثالثة والخامسة من العمر أصيب بسرطان الدم (اللوكيميا)؛ ودل على ذلك عظامه المليئة بالثقوب والناجمة عن سرطان نخاع العظام. ويتكون سرطان الدم في الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم، والتي تشمل نقي العظم والجهاز اللـِّمفي ويبدأ بالتكوّن في خلايا الالدم البيضاء، وبعدها يُنتج نقي العظم في الجسم كمية كبيرة جدا من خلايا الدم البيضاء الشاذة، التي لا يمكنها أن تقوم بوظائفها كما ينبغي بصدّ ومحاربة العدوى والمتلوثات المختلفة.
النتائج المستخلصة من دراسة المومياوات الفرعونية القديمة تؤكد أن الطبيب المصري القديم هو أول من اكتشف في العالم مرض البلهارسيا، ففي إحدى المومياوات المصرية المؤرخة بعصر الأسرة العشرين عثر عالم المومياوات سير مارك روفر عام 1910 على دودة بلهارسيا “شيستوسوما” متكلسة في الكلى، ما يؤكد ريادة الطب المصري القديم عالميا في التعرف على مرض البلهارسيا وتطبيبه. وهذا ما تؤكده المصادر الكتابية الهيروغليفية المصرية والتي سنتحدث عنها لاحقا. وفي مقابر هوارة عثر على بقايا ثمار التوت وهو ما يؤكد استخدم الفراعنة عصير التوت شراباً لعلاج حالات البلهارسيا. وعرفت مصر مرض الملاريا الذي أودى بحياة الكثير وخاصة في تل العمارنة ويرجح إصابة الملك توت عنخ آمون أحد ملوك الأسرة الـثامنة عشرة بالملاريا، كما توفيت إحدى زوجات الملك رمسيس الثاني أحد ملوك الأسرة التاسعة عشرة بهذا الوباء.
وتوثق دراسة بقايا المومياوات الفرعونية توظيف الأطراف الصناعية في مهنة الطب، ولكنها لم تكن عملية متقنة بما فيه الكفاية. ولم تستخدم فقط لجعل المتوفين أكثر أناقةً أثناء الجنازات، أو لأغراض التزيين، بل جرى تعويض بعض الأطراف الصناعية للأحياء. ففي بعض المومياوات على سبيل المثال نجد حالات بتر. وفي إحدى المومياوات المكتشفة بإحدى المقابر غرب طيبة في المنطقة التي تعرف حاليا باسم شيخ عبد القرنة في منطقة الأقصر بصعيد مصر القديمة، تم تعويض عضواً اصطناعياً، حيث عثر على إصبع من الخشب احتوى ظفر وصنع بعناية فائقة، وظف في تعويض إصبع القدم اليمنى الكبير المبتور أو المستأصل لامرأة كان يتراوح عمرها ما بين خمسين إلى خمسة وخمسين عاما. ويتكون الطرف الخشبي من ثلاثة أقسام مفصلية طليت باللون البني الغامق، وأحكم تثبيته بواسطة قطعة قماش عقدت حول الرجل وجرت عملية التعويض في أثناء حياة المرأة بدليل نمو طبقة ناعمة من الجلد مكان العضو المستأصل ووجود علامات احتكاك على الإصبع الخشبي. وكان الهدف من عمليات التعويض توفير نوع من التوازن وحرية الحركة نسبيا للمريضة أثناء المشي وأظهر فحص دقيق للقلب وعظام الأطراف السفلى أن المرأة كانت تعاني من مرض تصلب الشرايين، الذي يعيق الدورة الدموية في أطراف الجسم، وقد يستدعي بتر أعضاء لتجنب خطر الغرغرينا.
وفي دراسة لإحدى المومياوات الفرعونية يتضح إصابة بعض الأشخاص بالأمراض البكتيرية والفيروسية كأمراض الدرن “السل”. ومن خلال دراسة بقايا جثمان إحدى كهنة معبد آمون خلال فترة حكم الأسرة الحادية والعشرين تبين إصابته بمرض سل العمود الفقاري أو ما يعرف بمرض بوت الذي يسبب انخماصا واعوجاجا في الفقرات الظهرية، مما يؤدي إلى تحدب الظهر، ومن المضاعفات الخطيرة لمرض بوت التقيح الدرني الذي يصيب الفقرات وينتشر إلى أسفل تحت غشاء العضلة الحرقفية الكبرى في اتجاه الحرقفية ويظهر كخراج. وفي بقايا مومياء من الأسرة العشرين اكتشفت بقايا مرض جلدي يشبه مرض الجدري. وتشير المصادر الكتابية إلى إصابة رمسيس الخامس بمرض الجدري المائي.
وفي بقايا رفات تؤرخ بحوالي ٢٦٥٠ ق.م اكتشف ثقبين في الفك السفلي بالقرب من جذر الضرس الأول لعلاج نزيف ناتج عن خراج الأسنان. كما تم العثور على آثار “خراجات” داخل عظام الفك، والتي عولجت بالكي بالنار من خلال عود من الحديد. وعثر في عام 2012 على بعض المومياوات التي كانت تُعاني من تجويف الأسنان قبل وفاتها.
ودراسة ما يقارب المئتين من المومياوات وهياكلها العظمية في مقابر قبة الهوا جنوب أسوان والمؤرخة بالأسرة الثانية عشر 1760-1939 ق م، معظمها من الأطفال، يؤكد إصابة الموتى بأمراض معدية ونقص في التغذية.
ما سبق يؤكد أهمية دراسة البقايا الآدمية وبعض اللقى الأثرية في التعرف على الطب والأوبئة وممارسات التداوي عند إنسان عصور ما قبل التاريخ حتى تاريخ ابتكار نظام الكتابة وتدوين المعلومات الطبية على الطين والحجر والمعادن والخشب وورق البردي. وأيضاً رسوم ونقوش وتماثيل المعابد والمقابر والتي زودتنا بكثير من المعلومات الطبية المكملة لما استقيناه من دراسة البقايا الأدمية والنقوش الكتابية.
وبفضل الطب الحديث والمعاصر تمكنا من خلال دراسة المومياوات من التعرف على الكثير من الأوبئة التي هددت حياة البشر وخاصة مع ظهور مفهوم المدنية والتمدن وما رافق ذلك من تجمعات بشرية كبيرة. فضلا عن معرفة إنجازات الأطباء القدماء في عصر البرونز وعصر الحديد والعصر اليوناني والروماني والبيزنطي والإسلامي والأوربي الوسيط والحديث والمعاصر.
المصدر : سنمار سورية الاخباري