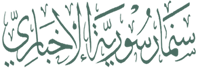عقب سقوط الأسد، ارتفعت رغبات وتصورات السوريين حول سورية الجديدة، وراح المواطنون والمسؤولون في سورية، يبنون “حلم دولتهم” ويقاربونها مع نماذج دولية عديدة، مشابهة في حد القحط والفقر والتدمير النموذج السوري. حيث تعتبر سوريا بلداً مدمراً بشكل شبه كامل، ويعيش أكثر من 90% من شعبها تحت خط الفقر، فضلاً عن وجود الملايين من اللاجئين في دول مختلفة.
وفي لاس فيغاس، صرّح وزير الخارجية السورية “أسعد الشيباني” بأنّ الرؤية السورية الجديدة، تركّز على تحويل سوريا إلى “سنغافورة” والاستفادة قدر الإمكان من هذه التجربة.
عقب ذلك اللقاء، بدأ السوريون يحتفون ويحلمون بتجربة بلد بني من الصفر، فهل التجربة السنغافورية بالفعل تجربة تنطبق على الحالة السورية؟ وماهي مقوماتها؟ وكيف تحققت؟ وهل المؤشرات الأولى بعد مرور خمسة أشهر على سقوط نظام الأسد تدلل على أنّ سوريا ستكون سنغافورة الجديدة؟ ولا سيما كل من الدولتين واجهتا “لحظة صفر سياسي”.
لم تكن سنغافورة التي تحتل في الناتج المحلي الإجمالي “Gross Domestic Product” المرتبة 31 عالمياً، سوى جزيرة متهالكة لا تزيد مساحتها عن 735 كيلومتراً مربعاً، حتى مياهها تأتي من ماليزيا، إذ كانت تعيش على نشاط قاعدتين عسكريتين بريطانيتين اللتين تشكلان حوالي 30% من الناتج المحلي، وضمن تركيبة اجتماعية معقّدة، في ظل عدم وجود أي ملامح مقومات دولة. وقد عاصرت بعد الحرب العالمية الثانية إلى مطلع الستينيات حروباً وصراعات طائفية داخلية بين الأكثرية الصينية وغيرهم من الملايويين والهنود والأورانغ والمكونات الأخرى.
لكن المحطة التاريخية الفارقة، كانت بظهور “حزب العمل الشعبي” منتصف الخمسينيات، بقيادة “لي كوان يو” وهو من الأغلبية الصينية الذي يعتبر مؤسس الدولة، ويطلق عليه مصطلح “الوزير المعلم” لكونه السبب الرئيسي في تشكيل الدولة وقيادة النهضة في البلاد.
يقول الوزير المعلم في كتابه “قصة سنغافورة ” لو كنت وزملائي نعلم عندما أنشأنا حزب العمل الشعبي حجم ونوعية المصاعب التي ستواجه رؤيتنا على طول الطريق الذي انتهجناه لما فكرنا بدخول معترك السياسة أصلاً، فلم يكن في أذهاننا آنذاك سوى فكرة واحدة وهي الخلاص من الاستعمار البريطاني، أما ما عدا ذلك فكنا نعتبره تفاصيل صغيرة ومشكلات تافهة يمكن معالجة كل منها في حينها، لكننا كنا مخطئين كثيراً، فنحن كنا في واقع الأمر نواجه مهمة ثقيلة وشاقة إلى أقصى الحدود، وهي تأسيس وإيجاد دولة وشعب وهوية من لا شيء”.
بدأت التجربة بالتركيز على ملفات عديدة، كان أهمها ما يمكن تسميته “نظام الجدارة” من خلال الخروج من السياسات التقليدية القديمة، وتشكيل فضاء اجتماعي ملائم لمكونات الشعب السنغافوري، وتنطلق فكرة هذا النظام بأنّ الأذكياء ليسوا فقط ضمن فئة “الأغنياء” وإنما كذلك ضمن فئة “الفقراء” أو ما يعرف حديثاً “رأس المال الاجتماعي” والانتقال من رأس مال السلطة إلى رأس مال “الوطن”. وذلك عبر الالتزام الأخلاقي بتحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
يركّز نظام الجدارة على قطاعات عديدة أهمها الاقتصاد والتعليم، مما دفع وقتها إلى بناء نظام تعليمي مناسب للحالة السنغافورية كمدخل أولي لبناء “الهوية الوطنية” الأمر الذي يتطلب بدرجة أساسية “صناعة النخبة” والذي يشمل “كل المواطنين” وكل طبقات المجتمع؛ لأنّ بناء النظام التعليمي على هذا الأساس سيفتح المجال أمام بناء نظم إدارية وحوكمية متقدمة في القطاعات العامة والخاصة، وهذا بالفعل ما حصل، حيث بدأت المؤسسات تستخدم أدوات نظام الجدارة وهو “HAIR” وهي سياسات تنموية تشير إلى: النزاهة والكفاءة وعدم القابلية للفساد والموارد البشرية كعنصر موردي وحيد وأساسي في الدولة الفتية، ساعد ذلك، على وجود مديرين في عمر الشباب في مناصب إدارية في مؤسسات مختلفة، بالتالي الاستفادة وتطوير موارد الشعب، وبناء “بيروقراطية الجدارة”.
لم يؤمن مؤسس الدولة في سنغافورة، بالديمقراطية كأداة للتغير، بل فضّل “التكنوقراط” وركّز على التنمية المستدامة والوعي الجمعي بفرض قوانين صارمة لتغير سلوك وعادات المواطنين أكثر من التركيز فقط على القيم السياسية.
من جانبها، اختارت الحكومة السورية الجديدة نظاماً مركباً يجمع بين الولاء والكفاءة وغالباً ما تميل للولاء -لحد اللحظة- وخاصة أنّ الظروف الأمنية مختلفة نوعاً ما، وقد بررت حكومة تصريف الأعمال نهجها بضرورات المرحلة المؤقتة، مما يعني أن سوريا لن تعتمد بشكل كامل على نظام الجدارة وإنما تتعامل مع الملف من مدخلات أمنية وليس تنموية إلا في الهوامش المتاحة، وهذا يبعدها عن صلب النموذج السنغافوري، ولعلّ هذه السياسات غير مرتبطة بالعقوبات الاقتصادية وإنما بعقلية ونهج الحكم.
بذات النسق، ركّزت الحكومة في سنغافورة على تحسين الظروف الاجتماعية لشعبها وذلك عبر تسهيل حياتهم المهنية والعملية، وضمان عدم المساس بالمواطنين أو إهانتهم، وقد عزز احترام الشعب لحكوماتها بتطبيق نظام “الادخار الوطني” CPF الذي ساعد المواطنين على امتلاك بيوت خاصة بهم بعد مرور فترة قصيرة. صحيح أن الحالة الاجتماعية السورية مختلفة، لكن مع ذلك تحاول الحكومة الجديدة تقديم وعود بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي للسوريين إذ ما زال من الصعب الحكم على مستوى وحجم التطور وما إن كان موجوداً.
في العلاقات الدولية، اعتمدت سنغافورة بعد إخراجها من “الاتحاد الماليزي” الأمر الذي دفع الوزير المعلم للبكاء على الهواء، على تحويل هذه الصدمة الاستراتيجية إلى فرصة لإعادة التفكير ببناء مدرستها الخارجية بالاعتماد على مصالحها ونفسها وعدم التبعية لدولة أخرى، فاتسمت المقاربة الخارجية بالحيادية الإيجابية وكان هناك رفض للانصياع لأيّة دولة، وكانت الفكرة تقوم على أنّ التجربة السنغافورية لا يمكن لها أن تنجو قبل تجاوزها إقليمها.
أصل الفكرة تنطلق بأنّه في الغالب الدول الكبيرة تتصارع على الدول الصغيرة، فكان لا بد من تحييد سنغافورة من هذه الصراعات؛ بعدم التبعية لأيّة دولة، لتجنيب البلاد صراعات قد تهدد المشروع التنموي، وهذا ما قامت به من خلال علاقات استراتيجية مع الصين وعدم الدخول في استقطاب مع الولايات المتحدة الأميركية، ورغم العلاقة المعقدة مع الجيران أي إندونيسيا وماليزيا إلا أنها اعتمدت على دور الدولة الصغيرة الصلبة “Hard Small State” وتوازن التفاوض مع القوة والحق، وضمان الردع من دون إثارة الخصوم.
في حين كان تموضع سوريا من الناحية الدولية والإقليمية أكثر تعقيداً، ولعلّه من الصعب على سوريا اعتماد مبدأ الحيادية الإيجابية رغم المحاولات الجادة ووجود دول داعمة، بخلاف التجربة السنغافورية التي كانت “شبه وحيدة” مما يزيد من فرص سوريا وخاصة مع سياسات ترمب الجديدة في الشرق الأوسط التي تركز على التهدئة. في المجمل تشارك سوريا التجربة السنغافورية صعوبة إعادة رسم تحالفاتها الإقليمية والدولية.
لم يؤمن مؤسس الدولة في سنغافورة، بالديمقراطية كأداة للتغيير، بل فضّل “التكنوقراط” وركّز على التنمية المستدامة والوعي الجمعي بفرض قوانين صارمة لتغير سلوك وعادات المواطنين أكثر من التركيز فقط على القيم السياسية، ورغم عدم الإيمان بالديمقراطية كمسار يطبق على التجربة، لكن مجرّد تتبع خطوات البناء التنموي قد عزز من القدرات الديمقراطية لأنّ أصل فكرة المساواة في الفرص وتشويق القدرات والتنافس هي مبدأ :ليبرالي”، مما وضع سنغافورة ضمن مصاف الدول الديمقراطية رغم سيطرة الحزب الواحد على الحياة السياسية، حيث ارتفع مؤشر الديمقراطية لأرقام كبيرة في السنوات الأخيرة، فحصلت على 6.14 في تصنيفها ضمن مؤشر الديمقراطية وهو رقم مرتفع، متفوقةً على دول عديدة منها تركيا وعدد من الدول الأوروبية بفارق درجتين على الأقل.
تبقى في نهاية المطاف التجربة السنغافورية تجربة عملية أكثر من أن تكون شفهية، ركّزت على التكنوقراط لكنها لم تهمل الحريات رغم كل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تحيط بها.